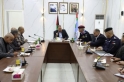- مقالات مختارة
- Friday-2023-12-22 | 05:20 pm

نيروز الإخبارية :
كتب /حسن نافعة
ما جرى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي يعدّ نقطة تحوّل في تاريخ النضال الفلسطيني. تلك حقيقة لم يعد بمقدور أي مراقب منصف إنكارها أو المجادلة في صحتها. فقبل هذا التاريخ، كانت مسيرة النضال السياسي قد وصلت إلى مأزق بسبب وصول عملية "أوسلو" إلى طريق مسدود، وكانت إدارة بايدن على وشك الإعلان في الوقت نفسه عن صفقة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية و"إسرائيل"، قوامها تبادل مصالح بين المملكة والولايات المتحدة لا علاقة له بالقضية الفلسطينية.
فقد أبدت إدارة بايدن استعدادها للموافقة على مطالب سعودية قديمة، أهمها إبرام معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة تماثل معاهدة حلف الناتو، ومساعدتها على إنشاء وتشغيل برنامج نووي سلمي يسمح لها بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في مقابل موافقة السعودية على مطالب أميركية مستحدثة، في مقدمتها التزام السعودية بالمحافظة على المصالح الأميركية والغربية في المنطقة والابتعاد عن كل من روسيا والصين، لكن المطلب الأميركي الأهم من السعودية كان الحصول على موافقتها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل".
وقد أبدت السعودية موافقتها من حيث المبدأ على إبرام هذه الصفقة، شريطة أن تقوم "إسرائيل" باتخاذ إجراءات تسمح بإعادة إحياء عملية التسوية السياسية وفتح الآفاق من جديد نحو حل الدولتين.
ولأنها لم تشترط قيام دولة فلسطينية أولاً قبل الإقدام على تبادل العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، فقد أصبح واضحاً آنذاك أن السعودية لم تعد تتمسّك بالمبادرة العربية التي أقرّتها قمة بيروت العربية عام 2002، رغم كونها مبادرة سعودية بالأساس، وباتت من ثم قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بركب الدول العربية الأخرى التي سبقتها على طريق "اتفاقيات أبراهام". ولم يكن لهذا التحوّل الخطير سوى معنى واحد وهو بداية دخول القضية الفلسطينية عملياً مرحلة التصفية النهائية، بعد أن ظلت لسنوات طويلة في مرحلة التيه والضياع.
في سياق كهذا، بدت القضية الفلسطينية في أمسّ الحاجة إلى ما يشبه الزلزال لإعادة تذكير العالم بها من جديد، وهو ما تحقّق بالفعل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رغم أنه بدا لكثيرين أشبه بالعمل الخارق، لكنه استطاع بالفعل قلب كل أوضاع المنطقة رأساً على عقب، وأجبر جميع الأطراف المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي على إعادة حساباتها مرة أخرى، ونجح من ثم في دفع القضية الفلسطينية من جديد إلى صدارة جدول أعمال النظامين الإقليمي والعالمي.
لقد استطاعت حماس، عبر عملية "طوفان الأقصى"، تضليل أقوى أجهزة الاستخبارات والتجسس في العالم، وألحقت بـ "الجيش الذي لا يقهر" هزيمة قاسية أسقطت أسطورته، وتمكّنت من أسر ما يكفي من العسكريين والمستوطنين لمقايضتهم بكل المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لم يكن ما تحقّق في هذه العملية البطولية هو الإنجاز الوحيد، وإنما أضيف إليه إنجازان لا يقلان روعة وإعجازاً، الأول: حين تمكّنت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة بقيادة حماس من الصمود في أطول حرب خاضها الكيان الصهيوني حتى الآن، بما في ذلك الحروب التي خاضها في مواجهة الجيوش العربية النظامية.
والثاني: حين صمد الشعب الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية في مواجهة حرب انتقامية همجية، تضمنت عمليات إبادة جماعية شنها "الجيش" الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، وراح ضحيتها ما لا يقل عن مئة ألف شخص في غزة وحدها بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض، والترحيل القسري لما يقرب من مليون ونصف مليون شخص، وحرمان جميع سكان القطاع البالغ عددهم ما يقرب من مليونين ونصف المليون من كل عناصر الحياة من مياه وغذاء وكهرباء وغيرها.
أما في الضفة الغربية، فقد قدّم الشعب الفلسطيني هناك مئات الشهداء والجرحى وآلاف المعتقلين في عمليات اقتحام ومطاردة مكثفة لم يسبق لها مثيل. غير أن هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها "جيش" الكيان الصهيوني هزت العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وذكّرت الجميع بأن للشعب الفلسطيني قضية عادلة يصرّ على الدفاع عنها بكلّ غال ونفيس، وهو على أتمّ استعداد لأن يبذل في سبيلها كل ما تستحقه من تضحيات، لأنها قضية وطن تم احتلاله منذ خمسة وسبعين عاماً، وقضية شعب ما زال محروماً حتى الآن من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
تقع على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه التضحيات والإنجازات الهائلة والبناء فوقها. ولكي لا تهدر وتذهب سدى، ينبغي على النخب السياسة والفكرية الفلسطينية، عموماً، وعلى الفصائل الفلسطينية، خصوصاً، أن تعمل على سد الثغرات الكثيرة التي يتوقّع أن تتسلل منها أطراف داخلية وخارجية كثيرة يهمها أن تسعى بكل ما أوتيت من قوة لسرقتها والانتقاص من قدرها، وبالتالي فعلى جميع النخب الفلسطينية أن تستعد منذ الآن لإدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بالقدرة والصلابة نفسها التي أدارت بها حماس مرحلة المواجهة والصدام.
إذ يتوقّع أن تصرّ الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو، وهي أكثر الحكومات تطرفاً وعنصرية في تاريخ "إسرائيل"، ليس على هزيمة حماس وإسقاط حكمها في غزة فحسب، ولكن أيضاً على انتهاز الفرصة لإجبار سكان القطاع على الرحيل القسري إلى مصر، كمرحلة أولى تتبعها مرحلة تالية على طريق إجبار سكان الضفة على الرحيل القسري إلى الأردن.
أما إذا عجز الكيان الصهيوني عن تحقيق هذا الهدف، فمن المتوقّع أن يتمسّك بنزع السلاح في كل القطاع مع فرض منطقة عازلة في شماله تخضع في الوقت نفسه لسيطرته الأمنية المباشرة. يلفت النظر هنا أن نتنياهو ما زال، حتى كتابة هذه السطور على الأقل، لا يصرّ على رفض وضع القطاع تحت إدارة حماس فحسب، ولكنه يصرّ على رفض وضعه تحت إدارة السلطة الفلسطينية أيضاً.
صحيح أنه قد يرضخ لاحقاً لضغوط أميركية تسعى لتمكين السلطة، بعد تجديد شبابها وتقوية مركزها، من إدارة القطاع، خصوصاً إذا عجز عن الحسم العسكري وأصبح في حاجة للبحث عن مخرج سياسي، غير أنه لا ينبغي الاعتماد على الإدارة الأميركية الحالية للقيام بأي عمل جاد يمكن أن يؤدي إلى إقامة دولة مستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، رغم حديثها الذي لا ينقطع عن استمرار تمسّكها بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد القادر على تجنّب وقوع مواجهات عسكرية في المستقبل.
فالأرجح أن يحاول بايدن استغلال الأزمة الراهنة لإدخال بعض التحسينات الشكلية على السلطة الفلسطينية، ومدّها بموارد تمكّنها من السيطرة الأمنية على قطاع غزة، بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية ومع حكومات بعض الدول العربية التي تتوق للتخلص من حماس، وذلك بالتوازي مع إطلاق "عملية سياسية" جديدة تستهدف إعادة تكريس وهم "حل الدولتين".
لذا ليس من المستبعد أن يسعى بايدن لإسقاط حكومة نتنياهو الحالية، والعمل على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تخلو من العناصر الدينية المتطرفة من أمثال غوفير وسموترتش.
ولأن هذا المنحى، وهو أخطر ما يمكن أن يواجهه الشعب الفلسطيني في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، لا يمكن أن يفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على الحد الأدنى من حقوقه المشروعة، بل ويستهدف في المقام الأول تمكين "إسرائيل" من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالوسائل العسكرية، يتعيّن على كل القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية الداعمة للمقاومة، الآن وليس غداً، أن تعمل بكل جدية على توحيد صفوفها حول برنامج وطني يستهدف إجهاض هذا المنحى وطرح تصوّر بديل في الوقت نفسه لكيفية إدارة النضال الفلسطيني في المرحلة المقبلة والبناء على ما حقّقته عملية "طوفان الأقصى" من إنجازات.
تجدر الإشارة هنا إلى أن شخصيات قيادية محسوبة على السلطة الفلسطينية. منها حسين الشيخ ومحمود هباش، كانت قد أدلت هذا الأسبوع بتصريحات إعلامية تلقي فيها باللوم على حركة حماس وتحمّلها مسؤولية ما ارتكبته "إسرائيل" من مذابح ومن عمليات إبادة جماعية في حق الفلسطينيين، باعتبارها الطرف المبادر بشن عملية "طوفان الأقصى"، بل وتوعّدت بمساءلة قياداتها في مرحلة لاحقة، وكأن مهمة فصائل المقاومة المسلحة هي القبول بالاحتلال كأمر واقع والجري وراء أوهام "أوسلو" التي لم تحقّق للفلسطينيين شيئاً طوال ثلاثين عاماً، وهذا منحى مقلق للغاية، إذ كان الأحرى بالسلطة الفلسطينية أن تبادر بطرح رؤية جديدة في هذه المرحلة تساعد على رصّ الصفوف بدلاً من إثارة عوامل الفرقة وتعميق أسباب الانقسام.
وفي تقديري أنه لم يعد أمام جميع النخب والفصائل السياسية والفكرية الفلسطينية من خيار آخر في هذه المرحلة سوى الاتحاد وبذل أقصى ما تستطيع من جهد لوقف العدوان الإسرائيلي وكسر الحصار وإدخال المساعدات العاجلة التي يحتاجها القطاع.
فهذه المرحلة بالذات، وهي بطبيعتها مرحلة انتقالية، تحتاج أكثر من أي مضى إلى وجود مرجعية فلسطينية موحّدة، تشارك في بلورتها كل العقول والقوى الوطنية في القطاع والضفة والشتات، تكون مهمتها الأساسية قيادة دفة الاتصالات والمفاوضات حول وضع غزة في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، والعمل على صياغة رؤية موحّدة حول كيفية إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني في مرحلة ما بعد "طوفان الأقصى".